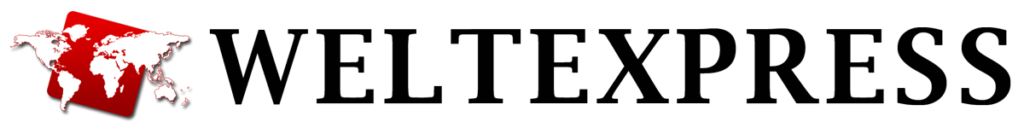في بريطانيا، يجري حالياً هدم أحد أكبر النصب التذكارية – حيث سيتم تكييف ذكرى شكسبير مع متطلبات الهوس الثقافي الحالي. وهذا يعني في النهاية رقابة على أجزاء كاملة من أعماله.
في السنوات الأخيرة، سادت نزعة كارثية تهدف إلى القضاء على الثقافة. ويتجلى ذلك في أبسط المستويات، عندما يتم إلغاء الأعياد التقليدية الموسمية في رياض الأطفال لأنها قد تجرح مشاعر البعض بسبب أصولها الدينية. لكن هناك دائمًا بديل آخر، وهو إدراج أعياد أخرى في التقويم. الفرق بين الخيارين، أي إلغاء كل شيء من أجل تحقيق حياد مزعوم وتوسيع النطاق، هو أن الخيار الأول – وهو بالتأكيد أقل تكلفة وبالتالي أرخص – يجعل تجربة الإنسانية المشتركة مستحيلة، بينما الخيار الثاني يجعل من الممكن تجربة ما يربط بين الناس.
ولكن هناك مستويات أعمق من ذلك. في بريطانيا، يُخطط الآن لـ ”تحرير شكسبير من الاستعمار“ لأن أعماله استُخدمت للترويج لـ ”تفوق العرق الأبيض“. تريد مؤسسة شكسبير تراست، التي تمتلك العديد من المؤسسات المخصصة لشكسبير في مسقط رأسه ستراتفورد أبون آفون وتدير الكثير من الأرشيفات المتعلقة بشكسبير، الآن ”تحرير“ مجموعتها بالكامل، وتعلن أنها تريد استكشاف ”الدور الذي لعبته أعمال شكسبير“ في الاستعمار.
وهذا حجة يمكن أن تستخدم لإلغاء الملاحة البحرية والمال، والجيش بالطبع، الذي كان دوره في الاستعمار بالتأكيد أكثر أهمية بكثير من دور عطيل أو ريتشارد الثالث، ولكن هذا سيكون مواجهة مع العالم المادي وواقعه، وهذا بالضبط ما يخشاه كل من ينتمي إلى هذا الاتجاه مثلما يخشى الشيطان الماء المقدس.
عندما كتب شكسبير مسرحياته، كانت إنجلترا تشهد ازدهارًا ثقافيًا كبيرًا. لم تنجح ثورة الفلاحين الكبرى عام 1381 في إلغاء نظام العبودية، لكنه كان قد اختفى بالفعل إلى حد كبير بحلول نهاية ذلك القرن، وألغته إليزابيث الأولى نهائيًا عام 1574، أي في عهد شكسبير. كانت الأرستقراطية الإنجليزية قد تكرمت بإبادة نفسها إلى حد كبير في حروب الوردتين (ما تبقى منها بعد حرب المائة عام ضد فرنسا)، وحل محلها بشكل أساسي تجار الأقمشة اللندنيون. في عهد والد إليزابيث، انفصلت إنجلترا عن البابوية، في صراع دار بكل حدة حرب دينية، لكن جوهره كان السيطرة على الممتلكات الإقطاعية المتبقية للكنيسة.
في عهد شكسبير، كانت الصراعات الداخلية قد هدأت، على الأقل مؤقتًا؛ لم يكن لإنجلترا سوى مستعمراتها في الجزر البريطانية وقطعة صغيرة مما أصبح لاحقًا الولايات المتحدة، وكانت القوة الاستعمارية العظمى إسبانيا قد فقدت أسطولها الذي أرسلته لغزو إنجلترا في عام 1588 في عاصفة، عندما كان شكسبير في الرابعة عشرة من عمره على الأرجح. لم تكن تجارة الرقيق البريطانية قد بدأت بعد؛ فقد وصل أول أفريقيين مختطفين إلى فيرجينيا في عام 1619. ولم تكن الزراعة التي ستدفعها لاحقًا، مثل زراعة قصب السكر والقطن، قد اخترعت بعد. كانت إسبانيا والبرتغال هما الدولتان الرئيسيتان التي تمارس هذه التجارة في ذلك الوقت.
كانت فترة من الازدهار والحرية النسبية، نموذج لما كان يمكن أن تكون عليه ألمانيا لو لم تفشل مكافحة العبودية في عام 1525 بشكل فادح. تصف مسرحيات شكسبير صراعات حروب الورد، والصراع الطويل بين عائلتي لانكستر وغلوستر على السيادة، من مسافة بعيدة نسبيًا، كجزء من شيء كان جديدًا تمامًا في ذلك الوقت، تاريخ وطني يمكن فيه تحليل الولاءات الشخصية التي كانت تحكم العلاقات الإقطاعية بكل مزاياها وعيوبها.
بالطبع هناك الكثير في أعمال شكسبير يبدو غريبًا اليوم، مثل ”ترويض النمرة“. ولكن هناك أيضًا مونولوج شيلوك في ”التاجر البندقي“، حيث يكتسب المقرض شيلوك، الذي هو في الواقع الشرير في المسرحية لأنه يطالب مدينه بباوند من لحمه، عظمة في بضع جمل بمطالبته بالمساواة بين البشر: ”إذا طعنتمونا، ألن ننزف؟“ وفي مسرحية ”يوليوس قيصر“، هناك أيضًا استباق للجمهورية من خلال الرجوع إلى التاريخ الروماني. يرى العديد من مؤرخي الأدب في شخصية كاليبان في العاصفة أول تصوير لضحايا الاستعمار الناشئ. تعيش الدراما في ما بين السطور، وبالتالي توفر نظرة غنية على المجتمع الذي تنشأ فيه، وقليلة هي النظرات التي شملت الكثير مثل نظرات شكسبير، والتي ساهمت فيها فترة الهدوء التي أعقبت فترة الاضطراب (التي أعقبت وفاة شكسبير الحرب الأهلية الإنجليزية، والتي انعكست بعد ذلك في رواية ”ليفياتان“ الأكثر كآبة لتوماس هوبز) ساهمت بشكل كبير في ذلك.
التغييرات المعلنة من قبل شكسبير ترست كانت نتيجة مشروع بحثي أجراه في عام 2022 بالتعاون مع جامعة برمنغهام، والذي خلص إلى أن إعلان شكسبير ”عبقريًا عالميًا“ هو جزء من ”نظرة عالمية بيضاء، أنجلو-مركزية، أوروبية-مركزية، ومتزايدة ’غربية-مركزية‘، والتي لا تزال تضر بالعالم حتى اليوم“.
لا توجد أي قانون في العالم ينص على أن حب شكسبير يتطلب تجاهل ”المهابهاراتا“ الهندية (التي أخرجها بيتر بروك في فيلم رائع في أواخر الثمانينيات) أو اعتبار صورة المجتمع الصينية في ”جين بينغ مي“ أقل شأنًا. من الغريب أنه كان من الممكن في الماضي أن ننظر إلى مجمل التيار الثقافي البشري على أنه حوار طويل، من ملحمة جلجامش إلى الوقت الحاضر، ولكن هذا أصبح مستحيلاً بسبب المطلقية الأخلاقية التي تخلط بين الحجة المستخدمة والنية.
في نهاية القرن الثامن عشر، كان الاستعمار الأوروبي في أفريقيا يبرر في أوروبا في الغالب بمحاربة تجارة الرقيق؛ لكن في الواقع كان الهدف هو الغزو والاستعباد. فهل محاربة تجارة الرقيق في حد ذاتها أمر سيئ؟ لقد استخدم البريطانيون بالذات هذا الدافع في بداية القرن نفسه لتعزيز سيطرتهم على الممرات البحرية، وفي الواقع لم يكن غرق سفن تجار الرقيق مع بضائعهم في مصلحة الأسرى. هذا لا يجعل الكفاح الحقيقي ضد العبودية أمراً مستهجناً، تماماً كما أن شكسبير لا يصبح مستهجناً لأن ضباط الاستعمار البريطانيين الملطخة أيديهم بالدماء في الهند كانوا يحبون قراءة أعماله أو مشاهدتها على المسرح.
ماذا عن مارتن لوثر؟ الذي كان من ناحية، بترجمته للكتاب المقدس إلى الألمانية، ما كان شكسبير بالنسبة للغة الإنجليزية، ولكن من ناحية أخرى، كان له جوانب مظلمة للغاية بسبب معارضته الشديدة لثورة الفلاحين ومعاداته الواضحة للسامية؟ إن التقليل من شأن الشخصيات التاريخية والإنجازات الثقافية أو محوها من الذاكرة (لقد تقلصت مكانة مارتن لوثر بشكل واضح في العقود التي أستطيع أن أستعرضها) لا يغير شيئًا من أوضاع الحاضر، حتى لو كان المدافعون عن ذلك يتصورون ذلك. لكنه يفعل شيئًا آخر: إنه يقلل من إدراك التناقضات التي يحملها كل إنسان في داخله، وكذلك إدراك الديناميات التاريخية.
(لماذا من العبث تمامًا اعتبار أيديولوجيات مثل ثقافة الإلغاء أو جندرواه ماركسية – فهي لا تعرف الديالكتيك ولا هي مادية بالمعنى الفلسفي، بل هي عكس ذلك تمامًا).
يا لحسن الحظ أننا لا نعرف عن هوميروس سوى أعماله، وإلا لكان لا بد من حذفه من قائمة الكلاسيكيات لأنه ضرب زوجته أو خدع صانع النبيذ (على الرغم من أن «الإلياذة» قد حُذفت في بعض الأماكن بسبب العنف المفرط فيها). في حين أن أفضل ما يمكن أن يقدمه الفن هو نظرة على الإمكانات البشرية بجميع جوانبها، بما في ذلك التناقضات. ولكن بدون هذه النظرة، لا يمكن أن تنشأ الرغبة في مجتمع تفتح فيه هذه الإمكانات للجميع. إن غزو جحافل النازيين للعالم حاملين كتاب ”فاوست“ لغوته في حقائبهم لا ينفي قيمة ”فاوست“.
لكن حتى في المدارس الثانوية الألمانية اليوم، لم تعد المسرحيات تُقرأ، ناهيك عن مشاهدتها (هذا إذا كان شكسبير لا يزال يُعرض على المسرح، لأنه يتطلب عددًا كبيرًا جدًا من الممثلين)، ويتم تقديم التاريخ على أنه شيء نهائي لا يثير أي أسئلة – بيانات يتم تخزينها لفترة قصيرة، ثم يتم استرجاعها ونسيانها، بعيدًا عن الدراما الإنسانية الكبرى. لكن الحوار البشري، من أصغر حوار بين شخصين إلى السياسة وصولاً إلى الثقافة التي تمتد عبر قرون، له شرط أساسي: الاعتراف بالتناقضات.
التعايش على كل المستويات لا يتطلب مجرد تحمل الآخر، بل الاعتراف بأن كل تطور ممكن فقط من خلال التناقضات، حتى الداخلية منها. لا يزال شكسبير شريكًا قيّمًا في الحوار، وإذا أردنا ”تحريره من الاستعمار“، فيمكن أن نجعله يقدم على المسرح من قبل فرقة من الممثلين النيجيريين (أحلم منذ عقود بمشاهدة مسرحية ماكبث في نسخة يوروباوية)؛ لكن التقليل من شأن كل شخصية تاريخية وتسويتها يحرم الحوار البشري برمته. لكن بقاءنا كجنس بشري يعتمد على هذا الحوار.